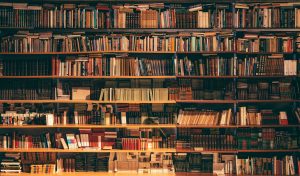 من الأخطاء اللغوية أنواعٌ تعود إلى تحريف المعاني، بسبب الانزياح الدّلالي الذي يقع للفظ، جرّاء استعماله في سياقات معيّنة.. فينحرف عن معناه الأصلي قليلاً أو كثيراً، وقد يصل به الحالُ إلى أن يأخذ معنى الضّدّ تماماً من معناه الأصلي.. ومن هذا النوع:
من الأخطاء اللغوية أنواعٌ تعود إلى تحريف المعاني، بسبب الانزياح الدّلالي الذي يقع للفظ، جرّاء استعماله في سياقات معيّنة.. فينحرف عن معناه الأصلي قليلاً أو كثيراً، وقد يصل به الحالُ إلى أن يأخذ معنى الضّدّ تماماً من معناه الأصلي.. ومن هذا النوع:
-
الشَّطارة:
فقد تحولت من معنى في منتهى السلبية، إلى قمة الإيجابية، وذلك عبر المسار التالي:
كان الشاطر في الأصل هو الرّجل الذي انشطر عن قبيلته أي خرج عن أعرافهم وفارقهم، يقول الخليل في معجم العين: “وشَطرَ فلانٌ على أهله، أي: تركهم مُخالفاً مُراغماً”. وبما أن المفارق لقبيلته قديماً، يتحوّل إلى حياة الصَّعلكة، فلا غروَ أن يعد من اللُّصوص، لذلك صار معنى الشاطر هو الخبيث؛ يقول الخليل: “ورجلٌ شاطرٌ، وقد شطر شُطوراً وشطاراً، وهو الذي أعيى أهله ومؤدِّبهُ خبثاً”.
بعد قرون من الاستعمال؛ ظهرت طبقة من اللّصوص في أواخر العصر العباسي يمثّلون الصعلكة المدنية؛ صاروا يعرفون “بالشُّطَّار”.. وما يزال الوصف سلبيّاً.. ولكن مع الوقت صار الشّطّار أصحابَ مهنة لها أصولها، التي تقتضي قدراً من الذّكاء والخِفّة والمهارة.. وهكذا تحوّل معنى: الشّطارة إلى: المهارة والذكاء؛ حتى وصلت العبارة إلى عصرنا وقد نُظّفت مما علق بها من السلبيات، وأصبح أكبر ما يمدح به الطالب هو الشطارة، وصار الشاطر كما في (المعجم المعاصر) هو: “حادّ الفهم، سريع التصرُّف”!
-
الاستهتار:
أصل مادة (هتر) هو: ذهاب العقل، كما في (تهذيب الأزهري).. ثم صار إلى معنى التعلق بالشيء بشدةٍ كما يفعل من فقد عقله ورشده؛ يقول الأزهري: “فأما الاستهتار فهو الوَلُوع* بالشَّيء والإفراط فيه، حتى كأنه أُهتِر: أي خَرِفَ”.
ثم أوردَ عدة استعمالات، منها ما نسب إلى الحديث الشريف بلفظ: «سبق المُفَرِّدُون. قالوا: وما المفرِّدون؟ قال الذين أُهتِرُوا في ذكر الله، يضعُ الذِّكر عنهم أثقالهم، فيأتون يوم القيامة خفافاً»، وجاء تفسيرُه في حديثٍ آخر: «همُ الذين اسْتُهْتِرُوا بذِكر الله»، أي أولعوا به. يقال: استُهتِر فلان بأَمرِ كذا وكذا: أي أُولع به”.
من الواضح إذن أن الاستعمال هنا إيجابيّ وإن كان مبنيا للمجهول؛ ولكن يبدو أن أغلب السياقات فيما بعد كانت تورد الاستهتار في التعلق بالأمور السلبية؛ مثل الخمر وما إليها.. وهكذا أمكن اختصار العبارة ووصف المرء “بالمستهتِر” من باب القدح.
ثم جاءت لغة الإعلام المعاصر؛ فانزاحت بالفعل عن مفعوله المحذوف، واخترعت له مفعولا جديدا بمعنى عكسِيٍّ؛ فصار المستهتر بالشيء هو المفرِّط فيه والتارك له بالكلية، بعد أن كان متعلقا به مفْرِطا في التعلق.
هامش:
* الوَلوع: مصدر على وزن فَعول بفتح الفاء شذوذاً، وهو من ضمن خمسة مصادر وردت على ذلك الوزن، أوردها سيبويه في الكتاب، ونظمها العلامة ابن رازگه الشنقيطي في قوله:
مَصادِرُ خَمسٌ قَد أَتَت بِفَعولِ *** بِفَتحٍ فخُذ مِن ظَفرِها بِوُصولِ
طَهورٌ وَقودٌ مَع وَلوعٍ وَزِد لَها *** وَضوءاً وَخَتمُ الكُلِّ لَفظُ قَبولِ

